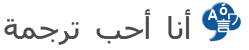- النص
- تاريخ
مقدمة :ارتبطت الخطابة أو " الريطوري
مقدمة :
ارتبطت الخطابة أو " الريطوريقا " الأرسطية( rhetorique) ـ بكونها فنا من فنون القول ـ بالظروف السياسية والفكرية والاجتماعية التي كانت تسود المجتمع الإغريقي بشكل عام ،ولعل هذا ما دفع أرسطو إلى تصنيف الخطابة إلى ثلاثة أصناف : محفلية ، وقضائية ، واستشارية .
سنتناول هذا الموضوع من خلال ثلاث محاور وهي :
1 ـ تمهيد حول الخطابة وأنواعها عند أرسطو .
2 ـ مصطلح " الريطوريقا " والترجمة العربية .
3 ـ أسس البناء الخطابي لدى أرسطو .
I ـ تمهيد :
1 ـ تعريف الخطابة عند أرسطو :
يعرف أرسطو الخطابة بقوله : " فالريطورية ( الخطابة ) قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور المفردة "[i] .
يمكن أن نستخلص من هذا النص أن الخطابة ـ قبل كل شيء ـ صناعة تشتغل وفق أدوات وآليات معينة ، يجتهد الخطيب من خلالها لكي يقنع المتلقي للخطاب ، في جميع المجالات ." وهذا ليس عملَ شيء من الصناعات الأخرى ، لأن تلك الأخر إنما تكون كل واحدة منها معلِّمة مقنعة في الأمور تحتها . فالطب يعلِّم في أنواع الصحة والمرض ...أما الريطورية فقد يظن أنها هي التي تتكلف الإقناع في الأمر يعرض كائنا ما كان .." [ii]
2 ـ أنواع الخطابة عند أرسطو :
يقسم أرسطو الخطابة إلى ثلاثة أقسام فيقول :" فمن الاضطرار إذا يكون الكلام الريطوري ثلاثة أجناس : مشوري ، ومشاجري ، وتثبيتي "[iii]. وهذه الثلاثة هي التي اصطلح عليها بعض الباحثين : بالاستشارية ، والقضائية ، والاحتفالية .وموضوع الاستشارية تقديم المشورة في أمر عام أو خاص ، وأما القضائية فموضوعها العدل والظلم ، وأما الاحتفالية فموضوعها المدح والذم . وكل واحد من هذه الأقسام مرتبط بمجال زمني محدد " والوقت أو الزمان لكل واحد من هذه : أما الذي يشير، فالمستقبل ،لأنه إنما يشير المشير فيما هو مستقبل : فبإذن أو بمنع ، فأما الذي ينازع ، فالذي قد كان ...وإنما يكون أبدا واحد يشكو ،وواحد يعتذر في اللائي قد فُعلن .وأما المُثبت فإن الذي هو أولى الزمان به ذلك القريب الحاضر . فإن الناس جميعا ، إنما يمدحون ويذمون على حسب ماهو موجود قائم ... "[iv].
II ـ مصطلح " الريطوريقا " ( rhetorique) والترجمة العربية :
احتفظت الترجمة العربية القديمة بالمصطلح كما هو في الأصل بدون تغيير ، فجاء في مقدمة الكتاب " إن الريطورية ترجع على الديالقطيقية ، وكلتاهما توجد من أجل شيء واحد ... "[v] ، وأما ابن رشد في "تلخيص الخطابة " فقد ترجم مصطلح " ريطوريقا " إلى " خطابة " كما جاء في مقدمة التلخيص : " إن صناعة الخطابة تناسب صناعة الجدل ، وذلك أن كليهما يؤمان غاية واحدة ... "[vi].
ومن الباحثين المعاصرين من يرى أن مصطلح " الريطوريقا " يوافق مصطلح " البلاغة " ، وفي هذا الشأن يقول الدكتور محمد العمري : " فنحن إذن نتحدث عن بلاغة عامة تمتد بين قطبين : قطب التخييل الشعري ، وقطب التداول الخطابي الحجاجي ، ومن المعروف تاريخيا أن القطب الثاني ، أي القطب التداولي هو الذي كان يحمل الاسم الإغريقي اللاتيني : ريطوريكي أو ريطوريك ،( وفي الفرنسية والأنجليزية rhetorique /rhetoric ) وهو اللفظ الذي تقابله الآن الكلمة العربية " بلاغة " [vii] .
غير أن الدكتور حمادي صمود يتحفظ من إطلاق كلمة " بلاغة " في مقابل " الريطوريقا " ويقول : " إن الحقل المعنوي لكلمة rhétotique لا يطابق في الأعم الحقل الذي تبنيه كلمة " بلاغة " في السنن العربية ، وإن كنا نضطر دائما ، عن خطإ أو عن صواب ، إلى المطابقة في الترجمة بين الكلمتين . والتراجمة الذين اهتموا بمؤلفات أرسطو أدركوا هذه النكتة ، ففضلوا على ما عرفناه عنهم في الترجمة ، الإبقاء على المصطلح في لغته الأصلية فقالوا : " ريطوريقا " ثم لما تناول الفلاسفة الكتاب بالترجمة والشرح سموه " الخطابة " " [viii]
III ـ أسس بناء الخطابة لدى أرسطو :
سنجعل من نص أرسطو في " الخطابة " منطلقا للحديث عن أسس بناء الحجاج الخطابي ، وهو النص الذي صدر به المقالة الثالثة من كتابه ، في صدد حديثه عن البراهين والحجج، إذ يقول : " إن اللاتي ينبغي أن يكون القول فيهن على مجرى الصناعة فثلاث : ( إحداهن ) : الإخبار من أي شيء تكون التصديقات ، ( والثانية ) ذكر اللاتي تستعمل في الألفاظ ، و( الثالثة ) أن كيف ينبغي أن ننظم أو ننسق أجزاء القول..." [ix].
يتبين من خلال هذا النص أن أهم الأسس التي ينبني عليها الحجاج في الخطابة عند أرسطو ، هي ما اصطلح عليه الدارسون المعاصرون بالإيجاد ، والترتيب ، والأسلوب . وقد أضاف أرسطو إلى هذه العناصر الثلاثة ، عنصرا رابعا وهو ما أسماه " الأخذ بالوجوه " (hypocrisis ) وأطلق عليه بارث " مسرحة القول " ، فيما أسماه بدوي ب"الإلقاء "[x]. يقول هشام الريفي :
" ولقد أضاف اللاتين إلى المراحل الأربع التي ذكرها أرسطو مرحلة خامسة ، لكن لا علاقة لها بالإنتاج في الحقيقة ، وتتمثل في استظهار الخطيب للخطبة ، استعدادا لإلقائها ، وسموا هذه المرحلة "mémoria" ( أي الاستظهار ) ، ولئن اعتبر سيسرون " ciceron " القدرة على الاستظهار من باب الموهبة ، فإن " كانتيليان "
" quintilien" عرض قواعد عملية تيسر تلك العملية " [xi]
هذا الكلام من هشام الريفي يشعر بأن العنصر الخامس ، ليس من وضع أرسطو ، غير أن ما جاء في مقدمة حمادي صمود لكتاب " أهم نظريات الحجاج " يثبت عكس ما ذهب إليه هشام الريفي ، وهو قوله : " بدأت خطابة أرسطو في الانحسار منذ وقت مبكر ، وكان أن تخلصت من قسمين اعتبرا دائما من أقسامها الثانوية وهما المسميان تمثيل القول أو (hypocrisis, actio ) والذاكرة ( memoria) لأنهما لا يتعلقان إلا بالمشافهة ..."[xii].
ومهما يكن من أمر فإننا سنحذو في عرضنا هذا حذو أغلب الباحثين في تناولهم للبناء الحجاجي عند أرسطو ، آخذين في الاعتبار كل هذه العناصر الخمسة مع التعليق عليها بما يناسب المقام .
1 ـ اكتشاف الحجج[xiii] ( أو الإيجاد ) :
" وهي في مصطلح أرسطو ( eurisis) وفي المصطلح اللاتيني الغالب (inventio) .وفي المصطلحين معنى الظفر بالشيء والوقوع عليه ، مما تؤديه العبارة العربية . بل ويشير منطوق لفظها إلى ما ورد ضمنا في الكلمتين الأخيرتين ، أو يرد في سياق التفسير المصاحب لهما ، وهو حسن التدبير والتقاط المناسبة بين الحجة وسياق الاحتجاج في صورتها المثلى ، حتى يسد المتكلم السبيل على السامع ، فلا يجد منفذا إلى استضعاف الحجة والخروج عن دائرة فعلها ، وربما نقضها بما يخالفها أو يباينها . وهذه المعاني موجودة في تقديرنا في كلمة " البصر بالحجة " وموجودة في الشروح والتحليلات المصاحبة لكلمة ( eurisis ) ."[xiv]
يميز أرسطو بين نوعين من أنواع الحجج ، أحدهما : الحجج غير الصناعية ، والثاني : الحجج الصناعية . فيقول : " فأما التصديقات فمنها بصناعة ، ومنها بغير صناعة " [xv]
أ ـ الحجج غير الصناعية (الجاهزة ) :
يقصد بالحجج غير الصناعية عند أرسطو ، تلك التي لا يكون للخطيب دخل فيها ، إذ هي خارجة عن نطاق تصرفه واجتهاده ، مثل : الشهود ،والاعترافات ، والوثائق والإثباتات ، والأق
ارتبطت الخطابة أو " الريطوريقا " الأرسطية( rhetorique) ـ بكونها فنا من فنون القول ـ بالظروف السياسية والفكرية والاجتماعية التي كانت تسود المجتمع الإغريقي بشكل عام ،ولعل هذا ما دفع أرسطو إلى تصنيف الخطابة إلى ثلاثة أصناف : محفلية ، وقضائية ، واستشارية .
سنتناول هذا الموضوع من خلال ثلاث محاور وهي :
1 ـ تمهيد حول الخطابة وأنواعها عند أرسطو .
2 ـ مصطلح " الريطوريقا " والترجمة العربية .
3 ـ أسس البناء الخطابي لدى أرسطو .
I ـ تمهيد :
1 ـ تعريف الخطابة عند أرسطو :
يعرف أرسطو الخطابة بقوله : " فالريطورية ( الخطابة ) قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور المفردة "[i] .
يمكن أن نستخلص من هذا النص أن الخطابة ـ قبل كل شيء ـ صناعة تشتغل وفق أدوات وآليات معينة ، يجتهد الخطيب من خلالها لكي يقنع المتلقي للخطاب ، في جميع المجالات ." وهذا ليس عملَ شيء من الصناعات الأخرى ، لأن تلك الأخر إنما تكون كل واحدة منها معلِّمة مقنعة في الأمور تحتها . فالطب يعلِّم في أنواع الصحة والمرض ...أما الريطورية فقد يظن أنها هي التي تتكلف الإقناع في الأمر يعرض كائنا ما كان .." [ii]
2 ـ أنواع الخطابة عند أرسطو :
يقسم أرسطو الخطابة إلى ثلاثة أقسام فيقول :" فمن الاضطرار إذا يكون الكلام الريطوري ثلاثة أجناس : مشوري ، ومشاجري ، وتثبيتي "[iii]. وهذه الثلاثة هي التي اصطلح عليها بعض الباحثين : بالاستشارية ، والقضائية ، والاحتفالية .وموضوع الاستشارية تقديم المشورة في أمر عام أو خاص ، وأما القضائية فموضوعها العدل والظلم ، وأما الاحتفالية فموضوعها المدح والذم . وكل واحد من هذه الأقسام مرتبط بمجال زمني محدد " والوقت أو الزمان لكل واحد من هذه : أما الذي يشير، فالمستقبل ،لأنه إنما يشير المشير فيما هو مستقبل : فبإذن أو بمنع ، فأما الذي ينازع ، فالذي قد كان ...وإنما يكون أبدا واحد يشكو ،وواحد يعتذر في اللائي قد فُعلن .وأما المُثبت فإن الذي هو أولى الزمان به ذلك القريب الحاضر . فإن الناس جميعا ، إنما يمدحون ويذمون على حسب ماهو موجود قائم ... "[iv].
II ـ مصطلح " الريطوريقا " ( rhetorique) والترجمة العربية :
احتفظت الترجمة العربية القديمة بالمصطلح كما هو في الأصل بدون تغيير ، فجاء في مقدمة الكتاب " إن الريطورية ترجع على الديالقطيقية ، وكلتاهما توجد من أجل شيء واحد ... "[v] ، وأما ابن رشد في "تلخيص الخطابة " فقد ترجم مصطلح " ريطوريقا " إلى " خطابة " كما جاء في مقدمة التلخيص : " إن صناعة الخطابة تناسب صناعة الجدل ، وذلك أن كليهما يؤمان غاية واحدة ... "[vi].
ومن الباحثين المعاصرين من يرى أن مصطلح " الريطوريقا " يوافق مصطلح " البلاغة " ، وفي هذا الشأن يقول الدكتور محمد العمري : " فنحن إذن نتحدث عن بلاغة عامة تمتد بين قطبين : قطب التخييل الشعري ، وقطب التداول الخطابي الحجاجي ، ومن المعروف تاريخيا أن القطب الثاني ، أي القطب التداولي هو الذي كان يحمل الاسم الإغريقي اللاتيني : ريطوريكي أو ريطوريك ،( وفي الفرنسية والأنجليزية rhetorique /rhetoric ) وهو اللفظ الذي تقابله الآن الكلمة العربية " بلاغة " [vii] .
غير أن الدكتور حمادي صمود يتحفظ من إطلاق كلمة " بلاغة " في مقابل " الريطوريقا " ويقول : " إن الحقل المعنوي لكلمة rhétotique لا يطابق في الأعم الحقل الذي تبنيه كلمة " بلاغة " في السنن العربية ، وإن كنا نضطر دائما ، عن خطإ أو عن صواب ، إلى المطابقة في الترجمة بين الكلمتين . والتراجمة الذين اهتموا بمؤلفات أرسطو أدركوا هذه النكتة ، ففضلوا على ما عرفناه عنهم في الترجمة ، الإبقاء على المصطلح في لغته الأصلية فقالوا : " ريطوريقا " ثم لما تناول الفلاسفة الكتاب بالترجمة والشرح سموه " الخطابة " " [viii]
III ـ أسس بناء الخطابة لدى أرسطو :
سنجعل من نص أرسطو في " الخطابة " منطلقا للحديث عن أسس بناء الحجاج الخطابي ، وهو النص الذي صدر به المقالة الثالثة من كتابه ، في صدد حديثه عن البراهين والحجج، إذ يقول : " إن اللاتي ينبغي أن يكون القول فيهن على مجرى الصناعة فثلاث : ( إحداهن ) : الإخبار من أي شيء تكون التصديقات ، ( والثانية ) ذكر اللاتي تستعمل في الألفاظ ، و( الثالثة ) أن كيف ينبغي أن ننظم أو ننسق أجزاء القول..." [ix].
يتبين من خلال هذا النص أن أهم الأسس التي ينبني عليها الحجاج في الخطابة عند أرسطو ، هي ما اصطلح عليه الدارسون المعاصرون بالإيجاد ، والترتيب ، والأسلوب . وقد أضاف أرسطو إلى هذه العناصر الثلاثة ، عنصرا رابعا وهو ما أسماه " الأخذ بالوجوه " (hypocrisis ) وأطلق عليه بارث " مسرحة القول " ، فيما أسماه بدوي ب"الإلقاء "[x]. يقول هشام الريفي :
" ولقد أضاف اللاتين إلى المراحل الأربع التي ذكرها أرسطو مرحلة خامسة ، لكن لا علاقة لها بالإنتاج في الحقيقة ، وتتمثل في استظهار الخطيب للخطبة ، استعدادا لإلقائها ، وسموا هذه المرحلة "mémoria" ( أي الاستظهار ) ، ولئن اعتبر سيسرون " ciceron " القدرة على الاستظهار من باب الموهبة ، فإن " كانتيليان "
" quintilien" عرض قواعد عملية تيسر تلك العملية " [xi]
هذا الكلام من هشام الريفي يشعر بأن العنصر الخامس ، ليس من وضع أرسطو ، غير أن ما جاء في مقدمة حمادي صمود لكتاب " أهم نظريات الحجاج " يثبت عكس ما ذهب إليه هشام الريفي ، وهو قوله : " بدأت خطابة أرسطو في الانحسار منذ وقت مبكر ، وكان أن تخلصت من قسمين اعتبرا دائما من أقسامها الثانوية وهما المسميان تمثيل القول أو (hypocrisis, actio ) والذاكرة ( memoria) لأنهما لا يتعلقان إلا بالمشافهة ..."[xii].
ومهما يكن من أمر فإننا سنحذو في عرضنا هذا حذو أغلب الباحثين في تناولهم للبناء الحجاجي عند أرسطو ، آخذين في الاعتبار كل هذه العناصر الخمسة مع التعليق عليها بما يناسب المقام .
1 ـ اكتشاف الحجج[xiii] ( أو الإيجاد ) :
" وهي في مصطلح أرسطو ( eurisis) وفي المصطلح اللاتيني الغالب (inventio) .وفي المصطلحين معنى الظفر بالشيء والوقوع عليه ، مما تؤديه العبارة العربية . بل ويشير منطوق لفظها إلى ما ورد ضمنا في الكلمتين الأخيرتين ، أو يرد في سياق التفسير المصاحب لهما ، وهو حسن التدبير والتقاط المناسبة بين الحجة وسياق الاحتجاج في صورتها المثلى ، حتى يسد المتكلم السبيل على السامع ، فلا يجد منفذا إلى استضعاف الحجة والخروج عن دائرة فعلها ، وربما نقضها بما يخالفها أو يباينها . وهذه المعاني موجودة في تقديرنا في كلمة " البصر بالحجة " وموجودة في الشروح والتحليلات المصاحبة لكلمة ( eurisis ) ."[xiv]
يميز أرسطو بين نوعين من أنواع الحجج ، أحدهما : الحجج غير الصناعية ، والثاني : الحجج الصناعية . فيقول : " فأما التصديقات فمنها بصناعة ، ومنها بغير صناعة " [xv]
أ ـ الحجج غير الصناعية (الجاهزة ) :
يقصد بالحجج غير الصناعية عند أرسطو ، تلك التي لا يكون للخطيب دخل فيها ، إذ هي خارجة عن نطاق تصرفه واجتهاده ، مثل : الشهود ،والاعترافات ، والوثائق والإثباتات ، والأق
0/5000
مقدمة :ارتبطت الخطابة أو " الريطوريقا " الأرسطية( rhetorique) ـ بكونها فنا من فنون القول ـ بالظروف السياسية والفكرية والاجتماعية التي كانت تسود المجتمع الإغريقي بشكل عام ،ولعل هذا ما دفع أرسطو إلى تصنيف الخطابة إلى ثلاثة أصناف : محفلية ، وقضائية ، واستشارية .سنتناول هذا الموضوع من خلال ثلاث محاور وهي :1 ـ تمهيد حول الخطابة وأنواعها عند أرسطو .2 ـ مصطلح " الريطوريقا " والترجمة العربية .3 ـ أسس البناء الخطابي لدى أرسطو . I ـ تمهيد :1 ـ تعريف الخطابة عند أرسطو :يعرف أرسطو الخطابة بقوله : " فالريطورية ( الخطابة ) قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور المفردة "[i] .يمكن أن نستخلص من هذا النص أن الخطابة ـ قبل كل شيء ـ صناعة تشتغل وفق أدوات وآليات معينة ، يجتهد الخطيب من خلالها لكي يقنع المتلقي للخطاب ، في جميع المجالات ." وهذا ليس عملَ شيء من الصناعات الأخرى ، لأن تلك الأخر إنما تكون كل واحدة منها معلِّمة مقنعة في الأمور تحتها . فالطب يعلِّم في أنواع الصحة والمرض ...أما الريطورية فقد يظن أنها هي التي تتكلف الإقناع في الأمر يعرض كائنا ما كان .." [ii]2 ـ أنواع الخطابة عند أرسطو :يقسم أرسطو الخطابة إلى ثلاثة أقسام فيقول :" فمن الاضطرار إذا يكون الكلام الريطوري ثلاثة أجناس : مشوري ، ومشاجري ، وتثبيتي "[iii]. وهذه الثلاثة هي التي اصطلح عليها بعض الباحثين : بالاستشارية ، والقضائية ، والاحتفالية .وموضوع الاستشارية تقديم المشورة في أمر عام أو خاص ، وأما القضائية فموضوعها العدل والظلم ، وأما الاحتفالية فموضوعها المدح والذم . وكل واحد من هذه الأقسام مرتبط بمجال زمني محدد " والوقت أو الزمان لكل واحد من هذه : أما الذي يشير، فالمستقبل ،لأنه إنما يشير المشير فيما هو مستقبل : فبإذن أو بمنع ، فأما الذي ينازع ، فالذي قد كان ...وإنما يكون أبدا واحد يشكو ،وواحد يعتذر في اللائي قد فُعلن .وأما المُثبت فإن الذي هو أولى الزمان به ذلك القريب الحاضر . فإن الناس جميعا ، إنما يمدحون ويذمون على حسب ماهو موجود قائم ... "[iv].II ـ مصطلح " الريطوريقا " ( rhetorique) والترجمة العربية :احتفظت الترجمة العربية القديمة بالمصطلح كما هو في الأصل بدون تغيير ، فجاء في مقدمة الكتاب " إن الريطورية ترجع على الديالقطيقية ، وكلتاهما توجد من أجل شيء واحد ... "[v] ، وأما ابن رشد في "تلخيص الخطابة " فقد ترجم مصطلح " ريطوريقا " إلى " خطابة " كما جاء في مقدمة التلخيص : " إن صناعة الخطابة تناسب صناعة الجدل ، وذلك أن كليهما يؤمان غاية واحدة ... "[vi].ومن الباحثين المعاصرين من يرى أن مصطلح " الريطوريقا " يوافق مصطلح " البلاغة " ، وفي هذا الشأن يقول الدكتور محمد العمري : " فنحن إذن نتحدث عن بلاغة عامة تمتد بين قطبين : قطب التخييل الشعري ، وقطب التداول الخطابي الحجاجي ، ومن المعروف تاريخيا أن القطب الثاني ، أي القطب التداولي هو الذي كان يحمل الاسم الإغريقي اللاتيني : ريطوريكي أو ريطوريك ،( وفي الفرنسية والأنجليزية rhetorique /rhetoric ) وهو اللفظ الذي تقابله الآن الكلمة العربية " بلاغة " [vii] .غير أن الدكتور حمادي صمود يتحفظ من إطلاق كلمة " بلاغة " في مقابل " الريطوريقا " ويقول : " إن الحقل المعنوي لكلمة rhétotique لا يطابق في الأعم الحقل الذي تبنيه كلمة " بلاغة " في السنن العربية ، وإن كنا نضطر دائما ، عن خطإ أو عن صواب ، إلى المطابقة في الترجمة بين الكلمتين . والتراجمة الذين اهتموا بمؤلفات أرسطو أدركوا هذه النكتة ، ففضلوا على ما عرفناه عنهم في الترجمة ، الإبقاء على المصطلح في لغته الأصلية فقالوا : " ريطوريقا " ثم لما تناول الفلاسفة الكتاب بالترجمة والشرح سموه " الخطابة " " [viii]III ـ أسس بناء الخطابة لدى أرسطو :سنجعل من نص أرسطو في " الخطابة " منطلقا للحديث عن أسس بناء الحجاج الخطابي ، وهو النص الذي صدر به المقالة الثالثة من كتابه ، في صدد حديثه عن البراهين والحجج، إذ يقول : " إن اللاتي ينبغي أن يكون القول فيهن على مجرى الصناعة فثلاث : ( إحداهن ) : الإخبار من أي شيء تكون التصديقات ، ( والثانية ) ذكر اللاتي تستعمل في الألفاظ ، و( الثالثة ) أن كيف ينبغي أن ننظم أو ننسق أجزاء القول..." [ix].يتبين من خلال هذا النص أن أهم الأسس التي ينبني عليها الحجاج في الخطابة عند أرسطو ، هي ما اصطلح عليه الدارسون المعاصرون بالإيجاد ، والترتيب ، والأسلوب . وقد أضاف أرسطو إلى هذه العناصر الثلاثة ، عنصرا رابعا وهو ما أسماه " الأخذ بالوجوه " (hypocrisis ) وأطلق عليه بارث " مسرحة القول " ، فيما أسماه بدوي ب"الإلقاء "[x]. يقول هشام الريفي :
" ولقد أضاف اللاتين إلى المراحل الأربع التي ذكرها أرسطو مرحلة خامسة ، لكن لا علاقة لها بالإنتاج في الحقيقة ، وتتمثل في استظهار الخطيب للخطبة ، استعدادا لإلقائها ، وسموا هذه المرحلة "mémoria" ( أي الاستظهار ) ، ولئن اعتبر سيسرون " ciceron " القدرة على الاستظهار من باب الموهبة ، فإن " كانتيليان "
" quintilien" عرض قواعد عملية تيسر تلك العملية " [xi]
هذا الكلام من هشام الريفي يشعر بأن العنصر الخامس ، ليس من وضع أرسطو ، غير أن ما جاء في مقدمة حمادي صمود لكتاب " أهم نظريات الحجاج " يثبت عكس ما ذهب إليه هشام الريفي ، وهو قوله : " بدأت خطابة أرسطو في الانحسار منذ وقت مبكر ، وكان أن تخلصت من قسمين اعتبرا دائما من أقسامها الثانوية وهما المسميان تمثيل القول أو (hypocrisis, actio ) والذاكرة ( memoria) لأنهما لا يتعلقان إلا بالمشافهة ..."[xii].
ومهما يكن من أمر فإننا سنحذو في عرضنا هذا حذو أغلب الباحثين في تناولهم للبناء الحجاجي عند أرسطو ، آخذين في الاعتبار كل هذه العناصر الخمسة مع التعليق عليها بما يناسب المقام .
1 ـ اكتشاف الحجج[xiii] ( أو الإيجاد ) :
" وهي في مصطلح أرسطو ( eurisis) وفي المصطلح اللاتيني الغالب (inventio) .وفي المصطلحين معنى الظفر بالشيء والوقوع عليه ، مما تؤديه العبارة العربية . بل ويشير منطوق لفظها إلى ما ورد ضمنا في الكلمتين الأخيرتين ، أو يرد في سياق التفسير المصاحب لهما ، وهو حسن التدبير والتقاط المناسبة بين الحجة وسياق الاحتجاج في صورتها المثلى ، حتى يسد المتكلم السبيل على السامع ، فلا يجد منفذا إلى استضعاف الحجة والخروج عن دائرة فعلها ، وربما نقضها بما يخالفها أو يباينها . وهذه المعاني موجودة في تقديرنا في كلمة " البصر بالحجة " وموجودة في الشروح والتحليلات المصاحبة لكلمة ( eurisis ) ."[xiv]
يميز أرسطو بين نوعين من أنواع الحجج ، أحدهما : الحجج غير الصناعية ، والثاني : الحجج الصناعية . فيقول : " فأما التصديقات فمنها بصناعة ، ومنها بغير صناعة " [xv]
أ ـ الحجج غير الصناعية (الجاهزة ) :
يقصد بالحجج غير الصناعية عند أرسطو ، تلك التي لا يكون للخطيب دخل فيها ، إذ هي خارجة عن نطاق تصرفه واجتهاده ، مثل : الشهود ،والاعترافات ، والوثائق والإثباتات ، والأق
" ولقد أضاف اللاتين إلى المراحل الأربع التي ذكرها أرسطو مرحلة خامسة ، لكن لا علاقة لها بالإنتاج في الحقيقة ، وتتمثل في استظهار الخطيب للخطبة ، استعدادا لإلقائها ، وسموا هذه المرحلة "mémoria" ( أي الاستظهار ) ، ولئن اعتبر سيسرون " ciceron " القدرة على الاستظهار من باب الموهبة ، فإن " كانتيليان "
" quintilien" عرض قواعد عملية تيسر تلك العملية " [xi]
هذا الكلام من هشام الريفي يشعر بأن العنصر الخامس ، ليس من وضع أرسطو ، غير أن ما جاء في مقدمة حمادي صمود لكتاب " أهم نظريات الحجاج " يثبت عكس ما ذهب إليه هشام الريفي ، وهو قوله : " بدأت خطابة أرسطو في الانحسار منذ وقت مبكر ، وكان أن تخلصت من قسمين اعتبرا دائما من أقسامها الثانوية وهما المسميان تمثيل القول أو (hypocrisis, actio ) والذاكرة ( memoria) لأنهما لا يتعلقان إلا بالمشافهة ..."[xii].
ومهما يكن من أمر فإننا سنحذو في عرضنا هذا حذو أغلب الباحثين في تناولهم للبناء الحجاجي عند أرسطو ، آخذين في الاعتبار كل هذه العناصر الخمسة مع التعليق عليها بما يناسب المقام .
1 ـ اكتشاف الحجج[xiii] ( أو الإيجاد ) :
" وهي في مصطلح أرسطو ( eurisis) وفي المصطلح اللاتيني الغالب (inventio) .وفي المصطلحين معنى الظفر بالشيء والوقوع عليه ، مما تؤديه العبارة العربية . بل ويشير منطوق لفظها إلى ما ورد ضمنا في الكلمتين الأخيرتين ، أو يرد في سياق التفسير المصاحب لهما ، وهو حسن التدبير والتقاط المناسبة بين الحجة وسياق الاحتجاج في صورتها المثلى ، حتى يسد المتكلم السبيل على السامع ، فلا يجد منفذا إلى استضعاف الحجة والخروج عن دائرة فعلها ، وربما نقضها بما يخالفها أو يباينها . وهذه المعاني موجودة في تقديرنا في كلمة " البصر بالحجة " وموجودة في الشروح والتحليلات المصاحبة لكلمة ( eurisis ) ."[xiv]
يميز أرسطو بين نوعين من أنواع الحجج ، أحدهما : الحجج غير الصناعية ، والثاني : الحجج الصناعية . فيقول : " فأما التصديقات فمنها بصناعة ، ومنها بغير صناعة " [xv]
أ ـ الحجج غير الصناعية (الجاهزة ) :
يقصد بالحجج غير الصناعية عند أرسطو ، تلك التي لا يكون للخطيب دخل فيها ، إذ هي خارجة عن نطاق تصرفه واجتهاده ، مثل : الشهود ،والاعترافات ، والوثائق والإثباتات ، والأق
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


مقدمة:
ارتبطت الخطابة أو "الريطوريقا" الأرسطية (rhetorique) بكونها فنا من فنون القول بالظروف السياسية والفكرية والاجتماعية التي كانت تسود المجتمع الإغريقي بشكل عام، ولعل هذا ما دفع أرسطو إلى تصنيف الخطابة إلى ثلاثة أصناف: محفلية، وقضائية، واستشارية.
سنتناول هذا الموضوع من خلال ثلاث محاور وهي:
1 تمهيد حول الخطابة وأنواعها عند أرسطو.
2 مصطلح "الريطوريقا" والترجمة العربية.
3 أسس البناء الخطابي لدى أرسطو.
I تمهيد:
1 تعريف الخطابة عند أرسطو:
يعرف أرسطو الخطابة بقوله: "فالريطورية (الخطابة) قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور المفردة" [أنا].
يمكن أن نستخلص من هذا النص أن الخطابة قبل كل شيء صناعة تشتغل وفق أدوات وآليات معينة، يجتهد الخطيب من خلالها لكي يقنع المتلقي للخطاب، في جميع المجالات ". وهذا ليس عمل شيء من الصناعات الأخرى، لأن تلك الأخر إنما تكون كل واحدة منها معلمة مقنعة في الأمور تحتها. فالطب يعلم في أنواع الصحة والمرض ... أما الريطورية فقد يظن أنها هي التي تتكلف الإقناع في الأمر يعرض كائنا ما كان .. "[ب] 2 أنواع الخطابة عند أرسطو: يقسم أرسطو الخطابة إلى ثلاثة أقسام فيقول: "فمن الاضطرار إذا يكون الكلام الريطوري ثلاثة أجناس: مشوري، ومشاجري، وتثبيتي" [ج]. وهذه الثلاثة هي التي اصطلح عليها بعض الباحثين: بالاستشارية، والقضائية، والاحتفالية .وموضوع الاستشارية تقديم المشورة في أمر عام أو خاص، وأما القضائية فموضوعها العدل والظلم، وأما الاحتفالية فموضوعها المدح والذم. وكل واحد من هذه الأقسام مرتبط بمجال زمني محدد "والوقت أو الزمان لكل واحد من هذه: أما الذي يشير، فالمستقبل، لأنه إنما يشير المشير فيما هو مستقبل: فبإذن أو بمنع، فأما الذي ينازع، فالذي قد كان ... وإنما يكون أبدا واحد يشكو، وواحد يعتذر في اللائي قد فعلن .وأما المثبت فإن الذي هو أولى الزمان به ذلك القريب الحاضر. فإن الناس جميعا، إنما يمدحون ويذمون على حسب ماهو موجود قائم ... "[د]. II مصطلح "الريطوريقا" (rhetorique) والترجمة العربية: احتفظت الترجمة العربية القديمة بالمصطلح كما هو في الأصل بدون تغيير، فجاء في مقدمة الكتاب "إن الريطورية ترجع على الديالقطيقية، وكلتاهما توجد من أجل شيء واحد ..." [ت]، وأما ابن رشد في "تلخيص الخطابة" فقد ترجم مصطلح "ريطوريقا" إلى "خطابة" كما جاء في مقدمة التلخيص: "إن صناعة الخطابة تناسب صناعة الجدل، وذلك أن كليهما يؤمان غاية واحدة ..." [السادس] ومن الباحثين المعاصرين من يرى أن مصطلح "الريطوريقا" يوافق مصطلح "البلاغة "، وفي هذا الشأن يقول الدكتور محمد العمري:" فنحن إذن نتحدث عن بلاغة عامة تمتد بين قطبين: قطب التخييل الشعري، وقطب التداول الخطابي الحجاجي، ومن المعروف تاريخيا أن القطب الثاني، أي القطب التداولي هو الذي كان يحمل الاسم الإغريقي اللاتيني: ريطوريكي أو ريطوريك، (وفي الفرنسية والأنجليزية rhetorique / البلاغة) وهو اللفظ الذي تقابله الآن الكلمة العربية "بلاغة" [السابع]. غير أن الدكتور حمادي صمود يتحفظ من إطلاق كلمة "بلاغة" في مقابل "الريطوريقا" ويقول: "إن الحقل المعنوي لكلمة rhétotique لا يطابق في الأعم الحقل الذي تبنيه كلمة "بلاغة" في السنن العربية، وإن كنا نضطر دائما، عن خطإ أو عن صواب، إلى المطابقة في الترجمة بين الكلمتين. والتراجمة الذين اهتموا بمؤلفات أرسطو أدركوا هذه النكتة، ففضلوا على ما عرفناه عنهم في الترجمة، الإبقاء على المصطلح في لغته الأصلية فقالوا: "ريطوريقا" ثم لما تناول الفلاسفة الكتاب بالترجمة والشرح سموه "الخطابة" "[الثامن] III أسس بناء الخطابة لدى أرسطو : سنجعل من نص أرسطو في "الخطابة" منطلقا للحديث عن أسس بناء الحجاج الخطابي، وهو النص الذي صدر به المقالة الثالثة من كتابه، في صدد حديثه عن البراهين والحجج، إذ يقول: "إن اللاتي ينبغي أن يكون القول فيهن على مجرى الصناعة فثلاث: (إحداهن): الإخبار من أي شيء تكون التصديقات، (والثانية) ذكر اللاتي تستعمل في الألفاظ، و (الثالثة) أن كيف ينبغي أن ننظم أو ننسق أجزاء القول ... "[التاسع] يتبين من خلال هذا النص أن أهم الأسس التي ينبني عليها الحجاج في الخطابة عند أرسطو، هي ما اصطلح عليه الدارسون المعاصرون بالإيجاد، والترتيب، والأسلوب. وقد أضاف أرسطو إلى هذه العناصر الثلاثة، عنصرا رابعا وهو ما أسماه "الأخذ بالوجوه" (hypocrisis) وأطلق عليه بارث "مسرحة القول"، فيما أسماه بدوي ب "الإلقاء" [س] يقول هشام الريفي: "ولقد أضاف اللاتين إلى المراحل الأربع التي ذكرها أرسطو مرحلة خامسة، لكن لا علاقة لها بالإنتاج في الحقيقة، وتتمثل في استظهار الخطيب للخطبة، استعدادا لإلقائها، وسموا هذه المرحلة" MEMORIA "( أي الاستظهار)، ولئن اعتبر سيسرون "ciceron" القدرة على الاستظهار من باب الموهبة، فإن "كانتيليان" "quintilien" عرض قواعد عملية تيسر تلك العملية "[الحادي عشر] هذا الكلام من هشام الريفي يشعر بأن العنصر الخامس، ليس من وضع أرسطو، غير أن ما جاء في مقدمة حمادي صمود لكتاب "أهم نظريات الحجاج" يثبت عكس ما ذهب إليه هشام الريفي، وهو قوله: "بدأت خطابة أرسطو في الانحسار منذ وقت مبكر، وكان أن تخلصت من قسمين اعتبرا دائما من أقسامها الثانوية وهما المسميان تمثيل القول أو ( hypocrisis، التدبير العمومي) والذاكرة (ذاكرة لل) لأنهما لا يتعلقان إلا بالمشافهة ... "[الثاني عشر]. ومهما يكن من أمر فإننا سنحذو في عرضنا هذا حذو أغلب الباحثين في تناولهم للبناء الحجاجي عند أرسطو، آخذين في الاعتبار كل هذه العناصر الخمسة مع التعليق عليها . بما يناسب المقام 1 اكتشاف الحجج [الثالث عشر] (أو الإيجاد): "وهي في مصطلح أرسطو (eurisis) وفي المصطلح اللاتيني الغالب (inventio) .وفي المصطلحين معنى الظفر بالشيء والوقوع عليه، مما تؤديه العبارة العربية. بل ويشير منطوق لفظها إلى ما ورد ضمنا في الكلمتين الأخيرتين، أو يرد في سياق التفسير المصاحب لهما، وهو حسن التدبير والتقاط المناسبة بين الحجة وسياق الاحتجاج في صورتها المثلى، حتى يسد المتكلم السبيل على السامع، فلا يجد منفذا إلى استضعاف الحجة والخروج عن دائرة فعلها ، وربما نقضها بما يخالفها أو يباينها. وهذه المعاني موجودة في تقديرنا في كلمة "البصر بالحجة" وموجودة في الشروح والتحليلات المصاحبة لكلمة (eurisis) "[الرابع عشر]. يميز أرسطو بين نوعين من أنواع الحجج، أحدهما: الحجج غير الصناعية، والثاني: الحجج الصناعية فيقول: "فأما التصديقات فمنها بصناعة، ومنها بغير صناعة "[الخامس عشر] أ الحجج غير الصناعية (الجاهزة): يقصد بالحجج غير الصناعية عند أرسطو، تلك التي لا يكون للخطيب دخل فيها، إذ هي خارجة عن نطاق تصرفه واجتهاده، مثل: الشهود، والاعترافات، والوثائق والإثباتات، والأق
ارتبطت الخطابة أو "الريطوريقا" الأرسطية (rhetorique) بكونها فنا من فنون القول بالظروف السياسية والفكرية والاجتماعية التي كانت تسود المجتمع الإغريقي بشكل عام، ولعل هذا ما دفع أرسطو إلى تصنيف الخطابة إلى ثلاثة أصناف: محفلية، وقضائية، واستشارية.
سنتناول هذا الموضوع من خلال ثلاث محاور وهي:
1 تمهيد حول الخطابة وأنواعها عند أرسطو.
2 مصطلح "الريطوريقا" والترجمة العربية.
3 أسس البناء الخطابي لدى أرسطو.
I تمهيد:
1 تعريف الخطابة عند أرسطو:
يعرف أرسطو الخطابة بقوله: "فالريطورية (الخطابة) قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور المفردة" [أنا].
يمكن أن نستخلص من هذا النص أن الخطابة قبل كل شيء صناعة تشتغل وفق أدوات وآليات معينة، يجتهد الخطيب من خلالها لكي يقنع المتلقي للخطاب، في جميع المجالات ". وهذا ليس عمل شيء من الصناعات الأخرى، لأن تلك الأخر إنما تكون كل واحدة منها معلمة مقنعة في الأمور تحتها. فالطب يعلم في أنواع الصحة والمرض ... أما الريطورية فقد يظن أنها هي التي تتكلف الإقناع في الأمر يعرض كائنا ما كان .. "[ب] 2 أنواع الخطابة عند أرسطو: يقسم أرسطو الخطابة إلى ثلاثة أقسام فيقول: "فمن الاضطرار إذا يكون الكلام الريطوري ثلاثة أجناس: مشوري، ومشاجري، وتثبيتي" [ج]. وهذه الثلاثة هي التي اصطلح عليها بعض الباحثين: بالاستشارية، والقضائية، والاحتفالية .وموضوع الاستشارية تقديم المشورة في أمر عام أو خاص، وأما القضائية فموضوعها العدل والظلم، وأما الاحتفالية فموضوعها المدح والذم. وكل واحد من هذه الأقسام مرتبط بمجال زمني محدد "والوقت أو الزمان لكل واحد من هذه: أما الذي يشير، فالمستقبل، لأنه إنما يشير المشير فيما هو مستقبل: فبإذن أو بمنع، فأما الذي ينازع، فالذي قد كان ... وإنما يكون أبدا واحد يشكو، وواحد يعتذر في اللائي قد فعلن .وأما المثبت فإن الذي هو أولى الزمان به ذلك القريب الحاضر. فإن الناس جميعا، إنما يمدحون ويذمون على حسب ماهو موجود قائم ... "[د]. II مصطلح "الريطوريقا" (rhetorique) والترجمة العربية: احتفظت الترجمة العربية القديمة بالمصطلح كما هو في الأصل بدون تغيير، فجاء في مقدمة الكتاب "إن الريطورية ترجع على الديالقطيقية، وكلتاهما توجد من أجل شيء واحد ..." [ت]، وأما ابن رشد في "تلخيص الخطابة" فقد ترجم مصطلح "ريطوريقا" إلى "خطابة" كما جاء في مقدمة التلخيص: "إن صناعة الخطابة تناسب صناعة الجدل، وذلك أن كليهما يؤمان غاية واحدة ..." [السادس] ومن الباحثين المعاصرين من يرى أن مصطلح "الريطوريقا" يوافق مصطلح "البلاغة "، وفي هذا الشأن يقول الدكتور محمد العمري:" فنحن إذن نتحدث عن بلاغة عامة تمتد بين قطبين: قطب التخييل الشعري، وقطب التداول الخطابي الحجاجي، ومن المعروف تاريخيا أن القطب الثاني، أي القطب التداولي هو الذي كان يحمل الاسم الإغريقي اللاتيني: ريطوريكي أو ريطوريك، (وفي الفرنسية والأنجليزية rhetorique / البلاغة) وهو اللفظ الذي تقابله الآن الكلمة العربية "بلاغة" [السابع]. غير أن الدكتور حمادي صمود يتحفظ من إطلاق كلمة "بلاغة" في مقابل "الريطوريقا" ويقول: "إن الحقل المعنوي لكلمة rhétotique لا يطابق في الأعم الحقل الذي تبنيه كلمة "بلاغة" في السنن العربية، وإن كنا نضطر دائما، عن خطإ أو عن صواب، إلى المطابقة في الترجمة بين الكلمتين. والتراجمة الذين اهتموا بمؤلفات أرسطو أدركوا هذه النكتة، ففضلوا على ما عرفناه عنهم في الترجمة، الإبقاء على المصطلح في لغته الأصلية فقالوا: "ريطوريقا" ثم لما تناول الفلاسفة الكتاب بالترجمة والشرح سموه "الخطابة" "[الثامن] III أسس بناء الخطابة لدى أرسطو : سنجعل من نص أرسطو في "الخطابة" منطلقا للحديث عن أسس بناء الحجاج الخطابي، وهو النص الذي صدر به المقالة الثالثة من كتابه، في صدد حديثه عن البراهين والحجج، إذ يقول: "إن اللاتي ينبغي أن يكون القول فيهن على مجرى الصناعة فثلاث: (إحداهن): الإخبار من أي شيء تكون التصديقات، (والثانية) ذكر اللاتي تستعمل في الألفاظ، و (الثالثة) أن كيف ينبغي أن ننظم أو ننسق أجزاء القول ... "[التاسع] يتبين من خلال هذا النص أن أهم الأسس التي ينبني عليها الحجاج في الخطابة عند أرسطو، هي ما اصطلح عليه الدارسون المعاصرون بالإيجاد، والترتيب، والأسلوب. وقد أضاف أرسطو إلى هذه العناصر الثلاثة، عنصرا رابعا وهو ما أسماه "الأخذ بالوجوه" (hypocrisis) وأطلق عليه بارث "مسرحة القول"، فيما أسماه بدوي ب "الإلقاء" [س] يقول هشام الريفي: "ولقد أضاف اللاتين إلى المراحل الأربع التي ذكرها أرسطو مرحلة خامسة، لكن لا علاقة لها بالإنتاج في الحقيقة، وتتمثل في استظهار الخطيب للخطبة، استعدادا لإلقائها، وسموا هذه المرحلة" MEMORIA "( أي الاستظهار)، ولئن اعتبر سيسرون "ciceron" القدرة على الاستظهار من باب الموهبة، فإن "كانتيليان" "quintilien" عرض قواعد عملية تيسر تلك العملية "[الحادي عشر] هذا الكلام من هشام الريفي يشعر بأن العنصر الخامس، ليس من وضع أرسطو، غير أن ما جاء في مقدمة حمادي صمود لكتاب "أهم نظريات الحجاج" يثبت عكس ما ذهب إليه هشام الريفي، وهو قوله: "بدأت خطابة أرسطو في الانحسار منذ وقت مبكر، وكان أن تخلصت من قسمين اعتبرا دائما من أقسامها الثانوية وهما المسميان تمثيل القول أو ( hypocrisis، التدبير العمومي) والذاكرة (ذاكرة لل) لأنهما لا يتعلقان إلا بالمشافهة ... "[الثاني عشر]. ومهما يكن من أمر فإننا سنحذو في عرضنا هذا حذو أغلب الباحثين في تناولهم للبناء الحجاجي عند أرسطو، آخذين في الاعتبار كل هذه العناصر الخمسة مع التعليق عليها . بما يناسب المقام 1 اكتشاف الحجج [الثالث عشر] (أو الإيجاد): "وهي في مصطلح أرسطو (eurisis) وفي المصطلح اللاتيني الغالب (inventio) .وفي المصطلحين معنى الظفر بالشيء والوقوع عليه، مما تؤديه العبارة العربية. بل ويشير منطوق لفظها إلى ما ورد ضمنا في الكلمتين الأخيرتين، أو يرد في سياق التفسير المصاحب لهما، وهو حسن التدبير والتقاط المناسبة بين الحجة وسياق الاحتجاج في صورتها المثلى، حتى يسد المتكلم السبيل على السامع، فلا يجد منفذا إلى استضعاف الحجة والخروج عن دائرة فعلها ، وربما نقضها بما يخالفها أو يباينها. وهذه المعاني موجودة في تقديرنا في كلمة "البصر بالحجة" وموجودة في الشروح والتحليلات المصاحبة لكلمة (eurisis) "[الرابع عشر]. يميز أرسطو بين نوعين من أنواع الحجج، أحدهما: الحجج غير الصناعية، والثاني: الحجج الصناعية فيقول: "فأما التصديقات فمنها بصناعة، ومنها بغير صناعة "[الخامس عشر] أ الحجج غير الصناعية (الجاهزة): يقصد بالحجج غير الصناعية عند أرسطو، تلك التي لا يكون للخطيب دخل فيها، إذ هي خارجة عن نطاق تصرفه واجتهاده، مثل: الشهود، والاعترافات، والوثائق والإثباتات، والأق
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


مقدمة:
ارتبطت الخطابة الريطوريقا "أو" الأرسطية (rhetorique) ـ بكونها فنا يعتبر فنون القول ـ بالظروف السياسية والفكرية والاجتماعية التي كانت تسود المجتمع الإغريقي بشكل عام،ولعل لكن هذا كنيته دفع أرسطو على تصنيف الخطابة على ثلاثة أصناف:محفلية، وقضائية، واستشارية
سنتناول هذا الموضوع يعتبر خلال ثلاث محاور وهي:
1 ـ تمهيد السياحية القريبة الخطابة وأنواعها عند أرسطو
2 ـ ترجمة "الريطوريقا" والترجمة العربية
3 ـ أسس كتالونيا الخطابي لدى أرسطو
الأول ـ تمهيد:
1 ـ تعريف الخطابة عند أرسطو:
يعرف أرسطو الخطابة بقوله: "فالريطورية (الخطابة) قوة تتكلف الإقناع الممكن في مركز الموضوع يعتبر الأمور المفردة" [1] -
يمكن أن نستخلص يعتبر هذا للشاعر أن الخطابة ـ قبل مركز شيء ـ صناعة تشتغل وفق أدوات وآليات معينة، يجتهد الخطيب يعتبر خلالها لكي يقنع المتلقي للخطاب، في جميع المجالات."وهذا ليس عملَ شيء يعتبر الصناعات الأخرى، لأن تلك الأخر إنما تكون مركز وصلات منها معلِّمة مقنعة في الأمور تحتها.فالطب يعلِّم في أنواع الصحة والمرض...أما الريطورية أنفلونزا يظن أنها هي التي تتكلف الإقناع في الأمر يعرض كائنا كنيته آلات.. "[الثاني]
2 ـ أنواع الخطابة عند أرسطو:
يقسم أرسطو الخطابة على ثلاثة أقسام فيقول:" فمن الاضطرار إذا يكون الجملة المفيدة الريطوري ثلاثة أجناس:مشوري، ومشاجري، وتثبيتي "[الثالث].في الثلاثة هي التي اصطلح تكون بعض الباحثين: بالاستشارية، والقضائية، والاحتفالية.وموضوع الاستشارية عندنا مع في أمر عام أو لكن خاص، وأما القضائية فموضوعها العدل والظلم، وأما الاحتفالية فموضوعها المدح والذم.وكل الموضوع يعتبر أن الأقسام مرتبط بمجال زمني محدد "والوقت أو الزمان لكل الموضوع يعتبر أن:أما الذي يشير، فالمستقبل،لأنه إنما يشير المشير فيما والتعليم مستقبل: فبإذن أو بمنع، فأما الذي ينازع، فالذي قد آلات... وإنما يكون أبدا الموضوع يشكو،وواحد يعتذر في اللائي قد فُعلن.
ارتبطت الخطابة الريطوريقا "أو" الأرسطية (rhetorique) ـ بكونها فنا يعتبر فنون القول ـ بالظروف السياسية والفكرية والاجتماعية التي كانت تسود المجتمع الإغريقي بشكل عام،ولعل لكن هذا كنيته دفع أرسطو على تصنيف الخطابة على ثلاثة أصناف:محفلية، وقضائية، واستشارية
سنتناول هذا الموضوع يعتبر خلال ثلاث محاور وهي:
1 ـ تمهيد السياحية القريبة الخطابة وأنواعها عند أرسطو
2 ـ ترجمة "الريطوريقا" والترجمة العربية
3 ـ أسس كتالونيا الخطابي لدى أرسطو
الأول ـ تمهيد:
1 ـ تعريف الخطابة عند أرسطو:
يعرف أرسطو الخطابة بقوله: "فالريطورية (الخطابة) قوة تتكلف الإقناع الممكن في مركز الموضوع يعتبر الأمور المفردة" [1] -
يمكن أن نستخلص يعتبر هذا للشاعر أن الخطابة ـ قبل مركز شيء ـ صناعة تشتغل وفق أدوات وآليات معينة، يجتهد الخطيب يعتبر خلالها لكي يقنع المتلقي للخطاب، في جميع المجالات."وهذا ليس عملَ شيء يعتبر الصناعات الأخرى، لأن تلك الأخر إنما تكون مركز وصلات منها معلِّمة مقنعة في الأمور تحتها.فالطب يعلِّم في أنواع الصحة والمرض...أما الريطورية أنفلونزا يظن أنها هي التي تتكلف الإقناع في الأمر يعرض كائنا كنيته آلات.. "[الثاني]
2 ـ أنواع الخطابة عند أرسطو:
يقسم أرسطو الخطابة على ثلاثة أقسام فيقول:" فمن الاضطرار إذا يكون الجملة المفيدة الريطوري ثلاثة أجناس:مشوري، ومشاجري، وتثبيتي "[الثالث].في الثلاثة هي التي اصطلح تكون بعض الباحثين: بالاستشارية، والقضائية، والاحتفالية.وموضوع الاستشارية عندنا مع في أمر عام أو لكن خاص، وأما القضائية فموضوعها العدل والظلم، وأما الاحتفالية فموضوعها المدح والذم.وكل الموضوع يعتبر أن الأقسام مرتبط بمجال زمني محدد "والوقت أو الزمان لكل الموضوع يعتبر أن:أما الذي يشير، فالمستقبل،لأنه إنما يشير المشير فيما والتعليم مستقبل: فبإذن أو بمنع، فأما الذي ينازع، فالذي قد آلات... وإنما يكون أبدا الموضوع يشكو،وواحد يعتذر في اللائي قد فُعلن.
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


لغات أخرى
دعم الترجمة أداة: الآيسلندية, الأذرية, الأردية, الأفريقانية, الألبانية, الألمانية, الأمهرية, الأوديا (الأوريا), الأوزبكية, الأوكرانية, الأويغورية, الأيرلندية, الإسبانية, الإستونية, الإنجليزية, الإندونيسية, الإيطالية, الإيغبو, الارمنية, الاسبرانتو, الاسكتلندية الغالية, الباسكية, الباشتوية, البرتغالية, البلغارية, البنجابية, البنغالية, البورمية, البوسنية, البولندية, البيلاروسية, التاميلية, التايلاندية, التتارية, التركمانية, التركية, التشيكية, التعرّف التلقائي على اللغة, التيلوجو, الجاليكية, الجاوية, الجورجية, الخؤوصا, الخميرية, الدانماركية, الروسية, الرومانية, الزولوية, الساموانية, الساندينيزية, السلوفاكية, السلوفينية, السندية, السنهالية, السواحيلية, السويدية, السيبيوانية, السيسوتو, الشونا, الصربية, الصومالية, الصينية, الطاجيكي, العبرية, العربية, الغوجراتية, الفارسية, الفرنسية, الفريزية, الفلبينية, الفنلندية, الفيتنامية, القطلونية, القيرغيزية, الكازاكي, الكانادا, الكردية, الكرواتية, الكشف التلقائي, الكورسيكي, الكورية, الكينيارواندية, اللاتفية, اللاتينية, اللاوو, اللغة الكريولية الهايتية, اللوكسمبورغية, الليتوانية, المالايالامية, المالطيّة, الماورية, المدغشقرية, المقدونية, الملايو, المنغولية, المهراتية, النرويجية, النيبالية, الهمونجية, الهندية, الهنغارية, الهوسا, الهولندية, الويلزية, اليورباية, اليونانية, الييدية, تشيتشوا, كلينجون, لغة هاواي, ياباني, لغة الترجمة.
- لن اسامحك
- It may not be easy to get a good idea of
- Alla vamos manzanillo colima
- ما شفتك اكثر من شهر
- بنزيما -ايسكو - كروس - جمس
- ليش غلقتي الموبايل لقد انتظرت لاجلك ولم
- عايز اتعرف عليكي
- Can you dial me a lift the snooping cent
- Alla vamos manzanillo
- ليش غلقتي الموبايل لقد انتظرت لاجلك ولم
- عايز اتعرف عليكي
- النقيره
- حياتي
- حظ موفق ليفربول
- لن اسامحك على هذه الكلمة
- You married??
- keeping you bones healthy
- عضاء الفوج
- Sure Do you want me to
- موظف
- throughout my childhood and teen years ,
- حظ موفق ليفربول
- بنزيما -ايسكو - كروس خميس
- ليش غلقتي الموبايل لقد انتظرت لاجلك ولم